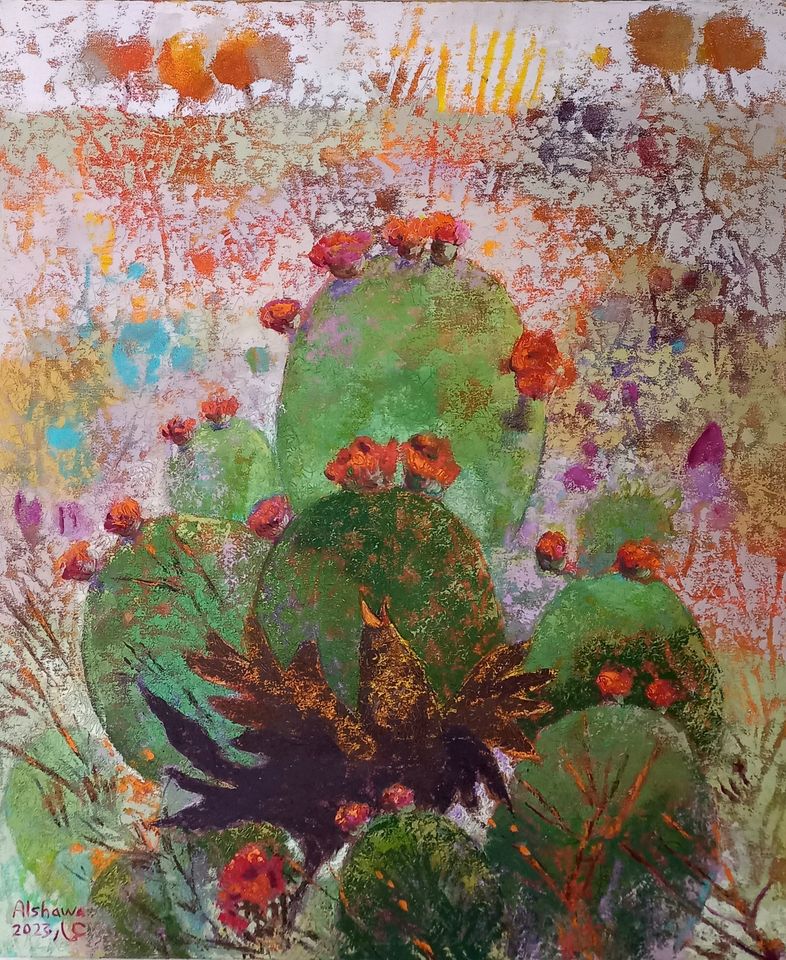من غزة المحاصرة والمُبادة، نداء للتحرير / هناء داوود
هناء داوود * ( فلسطين ) – الجمعة 9/2/2024 م …
يتعرض قطاع غزة منذ أكثر من شهر ونصف للقصف من قبل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط. يُسكَب الحديد والنار في غزة بلا هوادة فتُبقَر العمارات وتُهَشَم المشافي والمدارس والمخابز والكنائس والمساجد كما البنى التحتية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. مخيمات للاجئين استحالت غباراً، ومُسِحَت أحياء بأكملها وصارت رائحة الموت تنبعث منها. أكثر من 11200 ضحية أحصتهم وزارة الصحة في غزة، من بينهم 4630 طفلاً (وهذه هي الحصيلة المسجلة إلى حد يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر). 1.5 مليون شخص هُجِّروا من بيوتهم. وتتربص المجاعة والجفاف والأمراض الناجمة عن الحصار الكامل لجيب مطوَّق ومعزول ب2.3 مليون فلسطيني وفلسطينية.
“النزاع في فلسطين هو صراع للسيطرة على الأرض وسلبها من السكان الأصليين”، إدوارد سعيد، 1992.
يشهد العالم على إبادة جماعية محتملة بصدد الحدوث. “الإبادة” كلمة ثقيلة لكنها موزونة. 800 أكاديمي وحقوقي مختصون في دراسة الإبادات الجماعية عبّروا عن قلقهم وخوفهم من تكرارها في غزة. على أرض تبلغ مساحتها 360 كيلومتراً مربعاً، أي أقل من ثلث مساحة لندن، ألقي 25 ألف طن من المتفجرات في شهر واحد، وهو ما يعادل القوة التفجيرية لقنبلتين ذريتين. هيروشيما تدوي في غزة دون أن يكون لأي أحد منفذ للهرب. تُسخّر التكنولوجيات العسكرية الرائدة في خدمة مشروع إبادة جماعية، ويحظى هذا التجريب البشع المميت بمباركة الغرب.
“لا يهدف العنف الاستعماري إلى إخضاع البشر المستعبَدين فقط، بل يسعى أيضاً إلى تجريدهم من انسانيتهم”، جان بول سارتر، 1961.
حتى وان شحّت المعلومات والصور بشكل متعمد في الغرب، فإنها تُغرِق العالم العربي وجالياته في المهجر ومعهم كل الضمائر الحية التي تحرص على الاستفسار والفهم. بالطبع تضعنا مسألة بث ونشر الصور والمعلومات حول الفظائع المرتكبة أمام خيار صعب: هل هذا الأمر ضروري لبناء وجهة نظر مطّلعة؟ في السياق الحالي، يبدو ان الكفة تميل إلى الاجابة بنعم. عندما يُنظَر إلى الغارات باعتبارها مجرد عمليات عادية تدخل في “طبيعة” الحرب، فإن الطمس الممنهج والمنظم لحقيقتها يرسي نوعاً من النسبية التي تسمح بشكل ما للمعتدي بمواصلة اعتداءاته. في الواقع ليس من قبيل الصدفة أن تستهدف إسرائيل الصحافيين وعائلاتهم بشكل خاص، فعزل غزة عن العالم ومنع بث وتداول أي معلومة وأي صورة تُعّد رهانات أساسية للعدوان الإسرائيلي.
قنوات “الجزيرة” هي النافذة المطلّة على غزة، ومعها أيضاً شبكات التواصل الاجتماعي. وما تراه أعيننا هو المشهد المروع لمجزرة شاملة. أرضيات مشافي مغطاة بالدماء، وأجساد محتضِرة، ومقابر جماعية تتكدس فيها جثث متفحمة. في أحشاء عمارة منهارة جسد طفل يتدلى بعد أن علقت رأسه وسط الحطام. طفلة صغيرة مسجاة على الأرض يغطيها الرماد بشكل كامل ولا تظهر منها إلا خصلة من شعرها الكستنائي الفاتح. عينان غائرتان لرجل منهك وشارد الذهن يحمل بين يديه طفله الملتحف بكفن أبيض. طفلان متشبثان بجسد أمهما المشوه ومقطّع الأوصال، ويطبع أكبرهما قبلة على وجهها الخالي من الحياة. في مستشفى “العودة” يتجمع افراد من الأطقم الطبية، عاجزين، حول جسد معرَّى وليس لهم من مصدر إضاءة غير هواتفهم المحمولة. مواليد جدد في مستشفى “الشفاء” ممدَّدون الواحد تلو الآخر بعد أن توقفت حاضناتهم الاصطناعية عن العمل.
“في حدا سامعني؟!”
هذه الصرخة تدوي كل يوم في عدة أماكن من غزة. لا يزال هناك مئات الفلسطينيين، موتى وأحياء، يقبعون تحت الأنقاض. متسلحين في بعض الأحيان بمذراة وفي أغلبها بأياديهم العارية، يحاول الرجال والنساء القادمون لإغاثة العالقين القيام بما في وسعهم لإزاحة ركام المباني المنهارة.
ثم يدوي انفجار هائل جديد. تتصاعد سحابة من الدخان الأسود الكثيف في السماء، ومعها تتعالى من كل مكان موجات متتالية من صرخات الفزع والاستغاثة. جزعٌ وخوفٌ ورعب. لم تعد غزة سجناً مكشوفاً، بل تحولت إلى “مقبرة” على حد تعبير المتحدث باسم منظمة “يونيسيف”. تتساقط القنابل بشكل يومي ومتكرِّر على مستشفيات “الشفاء” و”الرنتيسي” و”الوفاء” و”النصر” و”الأندونيسي” و”القدس” و”العودة”.. بعد بضعة أيام فقط من الجدل الدولي حول هوية من يقف وراء قصف “المستشفى الأهلي”، تُقصف أقسام الولادة والعناية المركزة والعيادات الخارجية بلا هوادة. ليس هناك أدنى أشك بأن مبتغى الدولة الإسرائيلية لا يتعلق بالقضاء على “حماس”، بل بسحق الفلسطينيين والفلسطينيات. تسعى إسرائيل عبر محاصرتهم في جحيم من الوحشية إلى كسرهم جسدياً ونفسياً وسلبهم كل توق للحرية. ينفِّذ الجيش الاستعماري “للديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط” الحكم الذي أصدره: “فليركعوا ويصمتوا إلى الأبد!”. هذا الحقد المهتاج لا طائل منه.
“بالنسبة لأوروبا نحن نشكل هناك [أي في فلسطين] عنصراً في الجدار الذي يصد آسيا، وكذلك قاعدة متقدمة للحضارة في وجه الهمجية”. تيودور هرتزل، 1986.
“يجب أن نطرد العرب ونأخذ مكانهم”، ديفيد بن غوريون، من رسالة إلى ابنه، 1937.
اليوم وكما كانت الحال دائماً، لا يشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا القسم “الأبيض” من البشرية. في العالم الغربي، ما زال هناك منظومة أيديولوجية مشتركة لا يكون في داخلها للفلسطيني والعربي والأسود القيمة الوجودية نفسها التي لشعوب الشمال. تعود جذور هذه العنصرية إلى تاريخ الاستعمار الأوروبي، والذي تعد إسرائيل نتاجاً له. تقوم أصول الصهيونية – الحركة الاثنية/القومية التي وُلدت في أوروبا في القرن التاسع عشر – على فكرة جوهرية: “شعب بلا أرض لأرض بلا شعب”.
منذ البداية، نُظر إلى الفلسطينيين كحضور بلا وجود، مجرد “حيوانات بشرية” يجب القضاء عليها حتى يُفسح المجال لتوسع الحضارة الأوروبية في الشرق. في 1917، وعد اللورد بلفور – الوزير البريطاني الذي عرف بمعاداته للسامية – في رسالة وجهها إلى قادة الحركة الصهيونية بإقامة وطن قومي يهودي في فلسطين التي لم تكن حينها قد احتلت رسمياً من قبل المملكة المتحدة. حضر الفلسطينيون في هذه الرسالة بالنفي، باعتبارهم “جماعات غير يهودية” وغير أوروبية، أي لا شأن وقيمة لهم.
وهكذا بدأ الصراع على الأرض
كلما كان الفلسطينيون يفهمون أكثر الغايات الحقيقية للصهيونية – محو فلسطين واستبدالها – كلما كانت حدة استنفارهم تزداد ضد الانتداب البريطاني والاستعمار الصهيوني. في 1936 اندلعت الثورة الفلسطينية الأولى. قبلها ببضعة أشهر قُتل عز الدين القسام قائد أول كتيبة فلسطينية مسلحة. واليوم يحمل الجناح العسكري لحركة حماس اسم هذا القائد في استرجاع دائم لماضٍ لا يغيب. وتلا الإضراب المفتوح للعمال الفلسطينيين الذي استمر لستة أشهر، تطور الكفاح الفلسطيني المسلح طيلة سنة 1937. كان القمع البريطاني ضارياً ولم يستطع إخماد المقاومة المناهضة للاستعمار إلا بعد سنتين.
غداة الحرب العالمية الثانية صوَّت “المجتمع الدولي” – الذي تهمين عليه القوى الغربية – على خطة تقسيم فلسطين في الأمم المتحدة. أعطت هذه الخطة الضوء الأخضر لانطلاق نكبة 1948 وغزو فلسطين وعمليات التطهير العرقي التي تمّ خلالها تهجير 800 ألف فلسطيني وفلسطينية من أراضيهم.
في حيفا مثلاً اقتلعت ميليشيات صهيونية الفلسطينيين والفلسطينيات من بيوتهم وجمّعتهم في ميناء المدينة ثم أجبرتهم على ركوب قوارب صغيرة. وهكذا تم حينها إخلاء فلسطين من 80 في المئة من سكانها الأصليين. بعدها مباشرة أنشأت الدولة الإسرائيلية الجديدة لجنة تعيين أسماء كُلفت بنزع أسماء البلدات والقرى الفلسطينية واستبدالها بأخرى. وكانت مهمتها تتمثل في محو 14 قرناً من التاريخ العربي، وطمس عروبة فلسطين، وهدم الحاضر والماضي. هي عملية إبادة ممنهَجة للذاكرة، اكتسبت نجاعتها من تبني الغرب بأكمله لها. في قلب الأيديولوجيا الاستعمارية، وقلب الصهيونية أيضاً، هناك نفي للسكان الأصليين وإنكار لوجودهم بشكل مشبع باحتمالات الإبادة الجماعية. وجودهم المزعج يدفع إلى التطهير العرقي ومقاومتهم تستدعي تصفيتهم جسدياً.
في 1965 انبعثت “حرب العصابات” الفلسطينية من جديد مع تأسيس “قوات العاصفة” التابعة لحركة “فتح”. بعد الهزيمة العربية في حرب 1967، امتدت فكرة الكفاح المسلح إلى جميع التشكيلات السياسية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية. وانطلاقاً من الأردن ثم لبنان، توالت عمليات المجموعات الفلسطينية المسلحة وجسّدت منظمة التحرير الفلسطينية – التي كانت تهيمن عليها حركة فتح – آمال الشعوب العربية في تحرير فلسطين والوحدة العربية. وعلى العكس، تعاملت السلطات الإسرائيلية مع منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها منظمة إرهابية وحاربتها بصفتها تلك.
في 1982 حوصرتْ بيروت وقُصفت وشُوِّهَت. قصف الجيش الإسرائيلي العاصمة اللبنانية وطارد الشخص الذي يجسّد في عينيه الشر المطلق: ياسر عرفات (1929 – 2004). كان رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، مناحم بيغن، يعتبر أن “الفلسطينيين ليسوا بشراً، بل حيوانات بساقين اثنتين”. انهارت مدارس ومقرات صحف ومراكز بحث وفنادق ومحلات بقالة في بيروت بفعل الانفجارات، وعانى العديد من المدنيين – ومنهم مَن مات – من تأثير الحروق المستمرة التي تسببت بها غارات قذائف الفوسفور الأبيض. انتهت هذه الحلقة من التاريخ الفلسطيني والعربي بمغادرة 15 ألف مقاتل من “م.ت.ف” بيروت في نهاية صيف 1982. في سياق من تراجع اليسار على المستوى الدولي وعزلة “م.ت.ف” أُفتُتِحَ فصل جديد، وهو مسار ما سُمي ب”السلام” تحت مظلة الولايات المتحدة. وطيلة هذا المسار لم يتوقف الاستعمار الإسرائيلي أبداً عن ابتلاع فلسطين، وهذا منذ فترة رئاسة إسحاق رابين (1922 – 1995).
ما نشاهده اليوم في غزة هو حلقة جديدة في تاريخ طويل من الصراع على الأرض بين الفلسطينيين ودولة إسرائيل. وفي هذا الصراع يُجرَدُ الفلسطينيون من صفتهم البشرية بشكل متواصل، وهذه عملية متجذرة في الأيديولوجيا الاستعمارية الأوروبية. ولهذا فإن الصراع استعماري بحت، استعماري ولا شيء غير ذلك. كل رواية تأويلية أخرى، سواء استدعتْ حرب الأديان أو الحرب على الإرهاب، تمثل تلاعباً مربكاً يهدف إلى تمويه الحقيقة الاستعمارية للصراع وفي نهاية المطاف منع (وحتى تجريم) التضامن مع المُسْتَعْمَرِين.
“تحَسَّسَ مفتاحه مثلما يتحسَّسُ أعضاءه، واطمأنَّ”، محمود درويش، 1995.
غزة التي يقترن اسمها اليوم بالفوضى والخراب هي واحدة من أقدم المدن في العالم. هذه المدينة التي أسسها الكنعانيون قبل 3200 عاماً قبل المسيح ظلت طيلة آلاف السنين نقطة وصل بين مصر وسوريا، وكانت مندمجة بشكل كامل مع هذين القطبين في منطقة لم تعرف دولة قومية أو حدوداً وطنية قبل انهيار الإمبراطورية العثمانية. مدينة مزدهِرة جعل منها موقعها الجغرافي نقطة تجارية استراتيجية تثير المطامع، ومركزاً لجمع وتصدير محاصيل الحمضيات والقمح والشعير التي كانت تُنتَج في نواحيها.
قبل سنة 1948 كان لواء غزة في فلسطين الانتدابية يضم 90 مدينة وقرية، دُمِر نصفها وأُفرِغ من سكانه خلال نكبة 1948. بنيت كيبوتسات ومستوطنات إسرائيلية أخرى فوق القرى الفلسطينية القديمة. “سديروت” مثلا أُنشئت فوق قرية “نجد”، في حين بنيت “أشكلون/عسقلان” فوق قرى المجدل والجورة والخصاص ونعَليا. “تحت إسرائيل: فلسطين” كما لخص ذلك ايلان هاليفي في أحد مؤلفاته.
غداة النكبة تدهور النسيج الاجتماعي والاقتصادي لغزة بشكل بالغ. عُزِلَ قطاع غزة، الذي كان يشكل جزءا فقط من اللواء القديم، عن محيطه الإقليمي وتضاعف أربعة أضعاف عدد سكانه في سنة 1949. انتهى المطاف بحوالي 250 ألف لاجئ فلسطيني إلى غزة ما بين 1948 و1949. قَدِم 56 في المئة منهم من مدن وقرى لواء غزة القديم، و42 في المئة من لواء اللد الذي يضم قضائي يافا والرملة، وكان إسحاق رابين أحد القادة الذين أشرفوا على تطهيره العرقي في 1948. منذ مطلع خمسينيات القرن الفائت نظّم فلسطينيو وفلسطينيات غزة المقاومة ضد الاحتلال الاستعماري. وكان الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على مخيمات اللاجئين للرد على عمليات المسلحين الفلسطينيين الذين كانوا يتسللون إلى إسرائيل لاستهداف القواعد العسكرية.
في سنة 1971 قاد أرييل شارون عملية عسكرية واسعة في غزة دُمِرَت خلالها عشرات المساكن وأُبعِد 16 ألف فلسطيني في حين سجن 12 ألفاً آخرون في معسكر اعتقال أقيم على أرض سيناء المحتلة. استمرت المواجهات بين غزة والجيش الإسرائيلي بشكل متقطع طيلة عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الفائت والعقدين الأولين من الألفية الثالثة. وإنْ تغيّر المشهد السياسي الغزاوي بمرور الوقت – كانت حماس قوة سياسية صاعدة في عقد التسعينيات من القرن الماضي بحكم رفضها لاتفاقيات أوسلو- فإن منطق الصراع ظلّ هو نفسه. صراع مرتبط برقعة جغرافية -إسرائيل / فلسطين – وتشكّل سياسي واضح: الحرب الاستعمارية.
80 في المئة من سكان غزة الحاليين هم في الأصل لاجئون، أي رجال ونساء وأطفال لم تُمح ذاكراتهم الفردية والعائلية والجماعية عن عمليات التهجير التي ارتُكِبت في 1948. وإذا ما تمكن الغرب من فسخ الحقيقة الفلسطينية من ذهنه بشكل سريع، فإن الفلسطينيين والعرب لم يصابوا طبعاً بفقدان مفاجئ للذاكرة. ذكرى الأرض المسلوبة لا يمكن محوها، أما الاضطهاد الاستعماري فيُعاش بشكل يومي كجرح غائر في الجسد. في غزة تورِّث العائلات الأجيال القادمة مفاتيح بيوتها القديمة التي تحتفظ بها باعتبارها متاعهم الأغلى. حياتهم مركزة على أفق واحد: التحرير والعودة. فكرة العودة تستحوذ على قلوبهم وعقولهم.
هذه الجولة التاريخية المختصرة تُبرِز عدّة حقائق: 1) التاريخ لم يبدأ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، 2) الكفاح الفلسطيني المسلح لم ينطلق مع حركة حماس، 3) كفاح الشعب الفلسطيني هو نضال من أجل التحرر الوطني، 4) دولة إسرائيل هي نظام استعماري يُخضِع السكان الأصليين لوضع يجرِّدهم من إنسانيتهم، 5) “عنف المضطهِد يستدعي عنفاً مضاداً” (جان بول سارتر)، 6) قوة القصف الطوفاني الذي يستهدف غزة يقوده منطق استعماري يقوم على تحطيم المجتمع الفلسطيني، وهو يُنَفَذ على الأرض منذ 1948.
في هذا السياق هناك تذكير مفيد يفرض نفسه: لا يمكن للاستعمار التذرع بالدفاع المشروع عن النفس ضد المجتمعات التي يحتلها. وبهذا المعنى فإن “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” الذي تروِّج له جوقة القيادات السياسية ووسائل الإعلام الغربية ليس له أي نوع من الأساس القانوني فما بالك بالأخلاقي. على العكس، في حالة الاضطهاد الاستعماري يحُقُ للمستعمَرين أن يقاوموا، حتى باستعمال الأسلحة، طالما احترموا قواعد الحرب والقانون الدولي الإنساني.
علم إسرائيلي يرفرف على شاطئ في غزة
يتواصل المشروع الاستعماري الساعي لابتلاع فلسطين بتصلب أعمى في ظل تأييد ثابت من قبل الغرب الذي ما زال محكوماً بنظام الرؤية الاستعماري. علم إسرائيلي مغروس في غزة، وآخر في القدس، وثالث في الخليل. فليرفرف ألف علم إسرائيلي في فلسطين، هذه الأعلام لا يمكنها محو التاريخ الفلسطيني والعربي ولا التوق إلى الكرامة. لا شيء يمكنه إرواء العطش إلى الحرية. أرض فلسطين التاريخية – الأرض/الأم أو الأرض/الوطن – تنتصب في ذاكرة أهلها وتمتزج بها. فلسطين حقيقة حية، هي سعيٌ دائب إلى مستقبل خالِ من الاستعمار يقوم به الفلسطينيون والفلسطينيات وكل أنصار الحرية في العالم. فلسطين هي مدلول مناهضة الاستعمار في القرن الواحد والعشرين، وهي بهذا المعنى قضية كونية.
إزاء العدوان الذي يتخذ طابع الإبادة الجماعية في غزة، تتحمل البشرية مسؤولية تاريخية في انهاء جحيم الاستعمار الذي يتسبب في اغتراب الانسان الفلسطيني والإسرائيلي أيضاً، منذ 1948. النظام الاستعماري آلة تُجَرِّدُ المستعمَرين من إنسانيتهم وتخضعهم بواسطة الترهيب، وتنتج عنفاً غير محدود يتخذ طابع الإبادة الجماعية. اقترح كريغ مخيبر، المدير السابق لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك، خارطة طريق يجب أن تكون القاعدة المشتركة لمطالب كل المتضامنين مع القضية الفلسطينية. تدافع هذه الخارطة عن تحرير فلسطين، عبر إقامة ” دولة واحدة، ديمقراطية وعلمانية، في كل فلسطين التاريخية، مع حقوق متساوية للمسيحيين والمسلمين واليهود، وبالتالي تفكيك المشروع الاستعماري ذي الطابع العنصري العميق، وإنهاء الفصل العنصري في كامل أنحاء فلسطين التاريخية”.
عرباً ويهوداً، مناضلون يساريون ومناهضون للاستعمار، فلنوحد اصواتنا ونضاعف جهودنا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، ولإيصال نقاط كريغ مخيبر العشر إلى فضاءاتنا السياسية والجمعياتية والنقابية والثقافية وحتى حكوماتنا.
*باحثة من أصل فلسطيني، تعيش في إنجلترا
-نشر النص على موقع Contretemps بتاريخ 17 / 11 / 2023
-ترجمه من الفرنسية محمد رامي عبد المولى